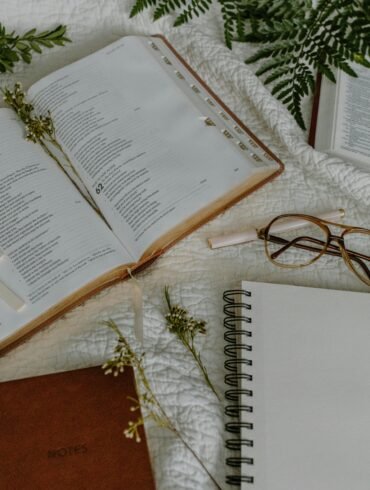جوانا وولش
ترجمة : إيمان الحريري
إن الآراء الواردة أدناه تعبر عن توجهات أصحابها، ولا تتبنى يقظة بالضرورة جميع التوجهات المذكورة في هذا المقال.
“ذاكرة الشذرات لا تولد إلا من الترميم، ومن رحم الترميم يولد الخلق، وما الخلق إلا رجاء يتجدد.” جوانا وولش
كنتُ في جولة للترويج لكتاب في المكسيك حين وصلني بالبريد الإلكتروني ملف يحوي أسئلة صحفية، استعدادًا لأمسيةِ قراءة. وقد كتب أحد الصحفيين يسأل: “لماذا تكتبين القصص القصيرة؟”
”ما الدّاعي للقصّةِ القصيرة؟” سؤال يشبه إلى حدٍّ ما ما كتبه صموئيل بيكيت: “ما أهمية من يتكلّم؟” إنه سؤال ينفتح على وجهين: وجه يبحث عن المعنى، وآخر يتعلّق بما يُقدَّم.
المعنى: ما أهمية الأمر؟
وما يُقدَّم هو: المحتوى.
أما المحتوى الذي تقدّمه القصة القصيرة، فهو القِصر نفسه، لا معيار آخر. ومع ذلك يبقى السؤال قائمًا، فالقصة القصيرة دائمًا موضع تساؤل، وربما كانت هي السؤال الذي يستحق أن يُطرح
السؤال الذي لطالما وُجِّه إليّ عن القصة القصيرة ليس عنها في جوهره. إنّما هو: “متى تكتبين رواية؟” وسؤال كهذا، رغم ما توحي به كلمة رواية من جدةٍ وابتكار، لا يحمل في نفسه أيّ جديد.
ومع أنّ فكرة كتابة رواية لا تزال تحوم كطيفٍ في أفق مستقبلي، فقد سبق أن كتبتُ بالفعل كتابين نُشرا بصفة روايات، لم أكتب أيًّا منهما وأنا أراه رواية، ولا خطر لي حينها أن أكتبه بهذا التصنيف. وأظنّ أنّني، حتى لو أردت، ما كنت لأقدر على ذلك.
“ليتنا نُشيد بالقصة القصيرة لا لقِصرها بل لسَعَتها؛ فكلما تشظّى الشيء وتوزّع تعددت زوايا النظر إليه واتّسعت مساحة المعنى.”
أولاً، لا أظن أن تجربتي تصلح لأن تسمّى رواية؛ فهي لا تتّخذ مسارًا واضحًا ولا تنمو كما تنمو الحكايات، بل تدور في دوّامات، وتتوزعُ إلى شذرات، تبدو كلّها كأنها بدايات معلّقة أو نهايات مفتوحة. فكمّ شيئًا ممّا كتبتُ لا يتحرّك عبر الزمن والمكان، إنّما عبر الأمل والذاكرة.
وهذا يعني أن تجربتي تتحرّك عبر اللغة، واللغة في جوهرها وسيلة للكلام عمَّا لا يُرى، أو عن ما له قيمة رغم غيابه. تمامًا كما في حكاية جوليفر لجوناثان سويفت، حين دخل بلادًا سنّ أهلها قانونًا غريبًا يقول: “ما دامت الكلمات مجرّد أسماء للأشياء، فالأجدر بالناس أن يحملوا معهم الأشياء نفسها ليستخدموها عند الحديث عمّا يريدون قوله.”
الرواية تحتاج إلى كثير من الموادّ، لكن في المحادثات القصيرة كما اكتشف جوليفر”يستطيع المرء أن يحمل في جيوبه وتحت ذراعيه ما يكفيه من أدوات للتعبير، وفي منزله لن يعجز عن العثور على ما يلزمه، ولهذا فإن الغرفة التي يجتمع فيها من يمارسون هذا الفن، تكون ممتلئة بكل ما يُحتاج إليه من أشياء مهيأة على الفور لتزويد هذا النمط من الحديث الاصطناعي بما يلزمه من مضمون.”
لأن القصة القصيرة تُبنى على القليل، فإن هذا القليل يُصبح أكثر حضورًا وأهمية. فالقصة القصيرة ليست كما وصف والتر بنيامين “شقةً مؤثثة على نحو ضخم بعشر غرف” وهي استعارة استخدمها لوصف الرواية في القرن التاسع عشر. وقد رأى أن ذروتها تتمثل في رواية شبح الأوبرا لغاستون ليرو، التي تبلغ 368 صفحة.
هذه الرواية كما يقول “تضمّ خزائن ضخمة منقوشة، وزوايا قاتمة لا تصلها الشمس تقف فيها أشجار النخيل، وشرفات مستترة وراء درابزين، وممرات طويلة يتراقص فيها وهج المصابيح المُهسهسة، كل هذا الاتساع والتفاصيل لا يليق به إلا أن يكون مأوىً لجثة، فما من سبيل في تلك الأريكة إلا أن تُقتل عليها العمة.”
هامش: يشبّه فالتر بنيامين الرواية الكلاسيكية في القرن التاسع عشر بشقّة واسعة فخمة مكوّنة من عشر غرف، تفيض بالأثاث الضخم والزخارف، والأركان الكئيبة، والممرات الطويلة المضاءة بألسنة لهب الغاز التي تُصدر صوتًا خافتًا.
هذه الصورة، التي استقاها من رواية شبح الأوبرا لغاستون ليرو (368 صفحة)، ترمز إلى الإفراط في الزينة السردية الذي يجعل الرواية كيانًا خانقًا، مكتظًا بالتفاصيل الزائدة، إلى حدّ أنها تفقد حيويتها، وتغدو مسرحًا للموت لا للحياة. ولهذا يقول ساخرًا: “لا بد أن تُقتل العمة على تلك الأريكة” — في إشارة إلى أن هذا العالم الروائي المتخم لا يصلح إلا ليكون مشهدًا لجريمة، لا بيتًا للسرد الحيّ.
اليوم، نؤثّث بطرق حديثة تشبه أثاث “إيكيا”: قطع مسطحة سهلة الحمل والتركيب، يمكن وضعها في أي مكان بكل سهولة. وهذا يشبه طريقة المحادثات القصيرة التي وصفها جوناثان سويفت، حيث تكون المحادثات قصيرة ومركّزة وتفي بالغرض بسرعة.
حين يكون كل شيء “مسطحًا” وقابلًا للتركيب، تصبح المساحات هي الأساس، والقطع المسطحة تُركّب معًا لتوهم بوجود حجم وعمق.
في المساحات الصغيرة، مثل القصة القصيرة، يحتاج الكاتب إلى استغلال هذه “الأسطح” — وهي هنا تمثّل الكلمات والعبارات واللغة — ليخلق عمقًا وثراء رغم قصر النص.
وعلى عكس المجتمع الذي وصفه سويفت والذي يركّز على الأشياء الملموسة والواقعية، فإن كُتّاب القصة القصيرة يتعاملون مع الوهم، أي يستخدمون اللغة ليخلقوا صورة وأحاسيس توحي بالواقع، رغم محدودية الحجم.
يهيّئ كُتّاب القِصص القصيرة فضاءات صغيرة، لا شققًا ذات عشر غرف، وينسجونها من اللاماديّ -المعنى، الشعور، الرمزية والإيحاءات- وهذا اللاماديّ حين يُجزّأ يُوهم بالسَّعة والاتساع.
لقد أصبحت “الشذرات” -والتي هي قطعة أدبية قصيوة ولكن مُكثفة- كيانًا أدبيًّا قائمًا منذ نحو زمن سويفت، حين بدأ الأثرياء من شمال أوروبا يجوبون البحر المتوسط في جولتهم كبرى بحثًا عن بقايا العالم الكلاسيكي، وهي التجربة التي قدّمتها رحلات جيليفر بأسلوب ساخر ومُحاكاتي.
وصفُ سويفت للُّغة بوصفها مادةً ليس محضَ استعارةٍ أدبية، بل هو موقفٌ ذو أبعادٍ سياسية دولية؛ فاللغة هنا أداة للتجارة والسياسية لا للتفام الحقيقي فهو يقول: “وهكذا يكون السفراء مؤهّلين للتفاوض مع أمراء أجانب أو وزراء دول، لا يفهمون لغة ألسنتهم بشكل مباشرة.” ولا عجب، ففي عام 1726 كانت الإمبراطورية البريطانية قد بدأت بالفعل في التوسّع باسم التجارة، حيث استبدلت اللغة – تلك اللامادية التي يكتب بها سويفت – بالبضائع المادية. واللغة، بطبيعتها، ليست سلعة مادية؛ لقد كتب جاك دريدا أنّها سُمٌّ، بينما لجأ غاستون ليرو إلى كتابة القصص القصيرة سعيًا وراء المكاسب المادية بعد أن بدّد ميراثه الكبير.
لُـيرو *مذكورٌ في موسوعة ويكيبيديا بوصفه “كاتبَ قصةٍ قصيرة” مع أنَّ عمله الأشهر كان رواية، ولعلّه عُدّ من كتّاب القصة القصيرة لأنّ هذا اللون الأدبي كان في زمانه جزءًا من ثقافةٍ رائجة، إذ كانت المجلات الأسبوعية والشهرية آنذاك تُفسِح المجال واسعًا أمام كتّاب القصص فصار ذاك ضربًا من ضروب الكسب. أمّا اليوم فقد ذوى ذلك الفنّ، ولم يعد موردًا يُعتدّ به كما يُسأل كل من يحاول سلوك سبيله “متى تكتبُ روايتك أنت؟”
من هم كتّاب القصة القصيرة، أولئك المتاجِرون بالشذرات؟ أهم سُيّاحٌ كبار في المعاني، أم أهلُ أرضٍ متكسّرة يبنون من أعمدتها بيوتًا بغرفةٍ واحدة، يؤثّثونها بأثاثٍ يُجمَع ويُركَّب؟ وربما كانوا هؤلاء أو أولئك، أو كليهما، وإن كان كلاهما نقيضًا لكلِّ واحدٍ منهما، على أي حال فإنّ ما يكتبونه من شظايا يحمل في طيّاته رجاءً وذكرى، لأنّ ذِكرى هذه الشظايا لا تكون إلا بصناعةٍ وتخيّل، كمن يعيد بناء ما تهدّم والخَلقُ كلّه أمل.
كلُّ كتابةٍ ضربٌ من التنقيب، أعمدةٌ تُنتزع من أرضٍ ميتة. وأنا حين أكتب لا أفكّر قط في “الاختراع”، فالمادّة التي أكتبها كامنةٌ تنتظر من يستخرجها أو ينبشها أو أيّ تعبيرٍ شئت، وإن كنتُ أستخرج فما أستخرج إلا من نفسي، وهل هذا حسن؟ لا أدري. ولا خيار لي في ذلك فهذا طريقي. وهكذا أُعلّم الكتابة أيضًا: أقول لطلّابي: أنتم تعرفون كل شيءٍ سلفًا، لا حاجة للتعلّم فقط انتشلوا ما سبق أن انتشلتموه كما قال جورج بيريك: «كلّ ما عليك هو أن تختار ما كنت قد اخترتَه من قبل.» لم يكن يكتب عن القصة القصيرة، ولكن إن كانت المادة منثورة في كل مكان فلمَ لا يُستعان بها فيها؟
إنّه كما قالت لي كريس كراوس: “كلّ الروايات عن العقارات.” نعم، تلك هي الروايات بشققها ذات العشر غرف. حتى بيريك كتب عن الشقق في كتابه أنواع الفضاءات، غير أنَّ الغرفة في نظره، “حيّز طيّع إلى حدٍّ بعيد”، رغم ما يقصده المعماريون و”لا طائل من محاولاتهم إقناعنا بالخزعبلات حول الوحدات النمطية وسواها.”
أما القصة القصيرة فهي للسُّكّان المؤقّتين للذين يَعون أنهم في فضاء انتظار. كاتب القصة القصيرة لا يلزمه أن يبني، ولا أن يُجِلّ نوايا المعمار، وذلك لأن اللغة في حقيقتها ليست تبادلاً للأشياء بل تبادلٌ لأسطحها فقط.
لكن تلك ليست سوى بعض القصص القصيرة، فثمّة ألف تعريفٍ وتعريف بل أكثر، كثيرٌ منها يضع قواعد دقيقة لبناء القصة القصيرة طوبةً فوق طوبة. وكذلك فالرواية لا يشترط أن تكون شقّة فاخرة مترامية الغرف إذ بوسعها أن تكون لوحةً مرسومة على “قطعة صغيرة من العاج” كما قيل. أيًّا يكن، فأنا لستُ من أهل القواعد ولا من عبّاد الصنعة، بل أميل إلى التوليف، إلى إعادة ترتيب الأثاث، أو تفكيكه وتحويله إلى شيءٍ آخر، كحيلةٍ من حِيَل “إيكيا” عملٌ صغير يُنجز في حيّزٍ ضيّق، كقول لوترِيامون: «اللقاء العارض بين آلة خياطة ومظلّة على طاولة جراحة» وهي تشكيلة من الأدوات والعمليات تنتمي لعصرٍ تَلَى ما يُسمّى بـ”الثورة الصناعية”.
القصة القصيرة سطحٌ قابل لإعادة التشكيل، ممتدّ من مادّة لا تُمسك، مادّة الرجاء والذكرى، وهي أوسع دائمًا من الغرفة الصغيرة التي يبدو أنها تحتويها.
وكذلك الروايات والقصص على السواء. رحلات غوليفر لا تُعدّ روايةً حقًّا، بل تُسمّى أحيانًا “روايةً أوليّة” وقد كانت جزءًا من نشوء هذا الشكل الأدبي في القرن الثامن عشر، ذاك الذي شهد ولادة القصة القصيرة أيضًا، أو بالأحرى انقسام الحكايات إلى طويلة وقصيرة. وكلاهما مرتبطٌ، على نحوٍ ما، بالثورة الصناعية: بمطابعها، وصحفها، ومحطّات قطاراتها، والتعليم والبعد والوقت الذي يُقضى بين مكانين، سواء طال أو قصر. حتى “الجولة الكبرى” التي كان يتّخذها المثقّفون توقّفت عن الوجود حين وصلت السكك الحديدية.
إنّ القصة القصيرة حقيقةٌ اقتصادية، وكذا الرواية، وذلك حتى قبل أن نتناول مادّتهما. فكلاهما محدَّدٌ بالأنظمة التي تُتيح له الوجود—كالجوائز التي خرج منها هذا الكتاب، وكالمكتبات المستقلة والمجلات، وكهذا الكتاب ذاته—أنظمة تُشجّع وتطبع وتُموّل. وغالبًا ما يُمتدح في القصة القصيرة “اقتصادها”، وفي ذلك دلالةٌ على نظرةٍ بعينها. أما أنا فأودّ أن أراها تُمتدح على سَعتها؛ إذ كلّما ازداد الشيء تكسُّرًا، ازدادت أسطحه.
وبينما صارت الكتابة أكثر قابليةً للحمل، صرنا نحن أقلّ حركة. نعمل اليوم من بيوتنا، على أثاثٍ نُركّبه بأيدينا. وحيثما كنّا، فنحن “نشتغل عن بُعد” دومًا على أهبة الانتقال، لكن لا ننتقل. كانت القصة القصيرة فيما مضى خرافةً، ثم صارت نادرة. أما الآن فهي شيءٌ آخر. القصة القصيرة سطحٌ يعاد تشكيله ممتدّ من مادّة لا تُمسك مادّة الأمل والذكرى، وهي دومًا أوسع من الغرفة الصغيرة التي يبدو أنها تأويها.
إن القصة القصيرة لا تكتفي بمساءلة المساحات والأشياء داخلها، بل تمتد لتسائل كيف توزَّع اللغة نفسها، ومن يملك حق الكلام؟ من يتكلم؟ من يُسمح له بأن يروي؟ وهذا سؤال وجودي ومعرفي، فيه نقد ضمني للبنى الاجتماعية والسياسية التي تتحكم في من يُسمَح له بالكتابة أو التعبير.
حين سألني الصحفي: لماذا تكتبين القصص القصيرة؟ لم يقلها بنبرة استفهام بل بنبرة استخفاف، بخلاف بيكيت. كان سؤاله كذاك التعليق الذي يهابه الكتّاب في قراءاتهم، ليس سؤالًا بقدر ما هو رأيٌ مُقنَّع، تعليقٌ من قبيل: “ولِمَ تفعل ذلك، ما الجدوى؟”. وفي هذه الحال لربّما كان جوابي -غير مبرر أبدًا- : نعم، أفعل لأني أفعل.
المقال الأصلي: Less Matters More: Joanna Walsh on the Expansive Possibilities of the Short Story